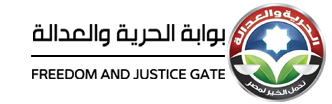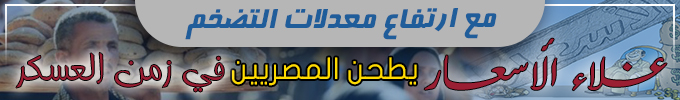41 عاما من التيه والتشرد على أبواب عواصم القرار، بعد أول معاهدة استسلام عربية صهيونية، والدولة الفلسطينية ما زالت حلما بعيد المنال، ومعاناة الفلسطينيين إرثا حزينا تتوارثه الأجيال، وأثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة داخل مصر وفي معظم الدول العربية، التي وقعها السادات منفردًا رغم أنف الشعب.
ومن ردود الأفعال الساخطة وقتها، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها “مذبحة التنازلات”، وكتب كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تُشير بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ومن المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، ما ترتب عليه إقامة سفارة للقاهرة في تل أبيب والعكس، وأقيم حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في فبراير 1980، وكانت لحظة رفع العلم الصهيوني في قلب عاصمة العرب لحظة تاريخية مؤلمة للمصريين، الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، حيث استقبل المصريون رفع العلم الإسرائيلي على السفارة غير المرحب بها، بالصراخ والعويل.
– القصة الكاملة لاتفاقية "كامب ديفيد" التي تم توقيعها من قبل الرئيس المصري الأسبق "أنور السادات" ورئيس وزراء الكيان الصهيوني "مناحيم بيغن" وما تمخض عنها من قرارات ونتائج : pic.twitter.com/xzn3EMjx2p
— وثائقي (@k41_ed) October 2, 2018
صفقة القرن
يقول الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزارة الأوقاف في عهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي:”معاهدة كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع الكيان الصهيوني هي خيانة القرن وأعلنت الدول العربية مقاطعتها له في حينها..إلا أن بعض دول الخليج الآن قررت تدارك ما فات واللحاق بركب السادات من خلال الجزء الثاني من الخيانة وهو صفقة القرن!!”.
اتفاقات كامب ديفيد لم تنجب سوى مسخ يسمى “صفقة القرن”، يسمع بها العرب ولا يعرفون تفاصيلها ولا موادها ولا أول فاصلة فيها ولا آخر نقطة، رغم أنها صيغت أصلا لتخليصهم من قضيتهم وإراحة ضمائرهم من عروس عروبتهم القدس.
وفجأة سقطت أمطار غزيرة واجتاحت ريح عاتية كامب ديفيد، وكأن الطبيعة تطلب منا مغادرة هذا المكان، وأثناء تناول الإفطار ترددت أصداء الرعد والبرق في كبد السماء، وقال أحد دبلوماسيينا إن السماء غاضبة مما يحدث في كامب ديفيد”، هذا الوصف ليس لأحد معارضي اتفاقية التسوية بين مصر وإسرائيل التي تسمى تجاوزا اتفاقية سلام، أو أحد منتقديها لكنه لأحد القائمين عليها وهو بطرس غالي وزير الخارجية آنذاك، يصف من خلالها الأجواء التي عاشها الوفد المصري الذي شارك في توقيع هذه الاتفاقية بين مصر وإسرائيل قبل واحد وأربعين عاما.

ذكر بطرس غالي هذا في الصفحة 154 من مذكراته عن اتفاقية السلام التي نشرها تحت عنوان: “طريق مصر إلى القدس” ليكشف عن تلك الأجواء البائسة التي سبقت توقيع هذه الاتفاقية التي أنهت الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل، لكنها لم تخلق السلام لا بين شعوب المنطقة ولا بين أنظمتها التي تفرغت لخصوماتها وتصفية حساباتها مع بعضها البعض ومع شعوبها في آن معا.
ورغم مرور 41 عاماً فإن الاتفاقية ما زالت محل جدل وخلاف كبيرين في الشارع السياسي العربي الذي تنقسم رؤيته ما بين قلة قليلة مؤيدة للاتفاقية بحجة أنه ليس للعرب حول ولا قوة، وأكثرية ساحقة رافضة لها ولبنودها وترى أنها سبب الخراب الذي حل بالعرب بعدها وأصل البلاء.. كل البلاء.
هذه الذكرى تفرض إعادة قراءة الخطوة المفاجئة التي أقدم السادات بمبادرته لبدء هذا الحدث التاريخي، والذي جعله واحدا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فالبعض يصفه بالسياسي الحكيم المحنك والبعض الآخر يرى ما قام به وتوقيعه لاتفاقيه ومعاهدة سلام مع إسرائيل العدو الأول للعرب نوعا من الخيانة، وتنازلا صريحا عن القضية الفلسطينية، التي تنهش إدارة دونالد ترامب حاليا آخر اللحم الحي فيها، وتقطع عن سلطتها الوطنية البائسة كل ما يسد الرمق ولا يغني عن جوع، وتطرد ممثلها من واشنطن، وكل هذا تحت شعار:”الدفع نحو السلام” أو نحو الاستسلام!
هل #السيسي أفضل رئيس يحكم #مصر بالنسبة للإحتلال لانه أحد أبناء كامب ديفيد ؟#شاهد الحقيقة مع محمد ناصر pic.twitter.com/LCK9WDBsmP
— محمد ناصر علي (@M_nasseraly) September 17, 2018
إرهاب السيسي
القراءة تفرضها أيضا حرب جنرالات الانقلاب العسكري على الشبح، أو الظل الذي بات يسمى بـ”الإرهاب” في منطقة سيناء، وتأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد التي تفرض حدودا ضيقة جدا على التسليح المصري في شبه الجزيرة، فعلى الرغم من مضي كل هذه السنوات على توقيع كامب ديفيد لعام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 ، لا يزال الجدل قائما حولها في الوطن العربي، لأنها خلّفت نتائج وتداعيات كارثية على الأمة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وأضافت تعقيدات جديدة للصراع العربي الصهيوني، ليس آخرها سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقضم الضفة الغربية والقدس وتكاد تلتهم حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.
سعد الدين الشاذلي يتحدث في حوار مع "آسوشيتدبرس" عندما كان سفيرًا لمصر في البرتغال وذلك قبل توقيع مصراتفاقية كامب ديفيد بثلاثة أشهر
▪وتحل اليوم الذكرى الثامنة لوفاة الفريق #سعد_الدين_الشاذلي #ما_رواه_الناس Video Credit: AP pic.twitter.com/uMdlWAYfLI— المنصة (@Almanassa_AR) February 10, 2019
وعلى الرغم من “تدافع” العرب إلى التفاوض مع إسرائيل حينا في العلن وغالبا في السر، متخذين من الخط الذي رسمته “كامـب ديفيد” خيارا وحيدا للتوصل إلى سلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل ما تزال ترفض الاعتراف بالحقوق العربية، وتضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على تلك الحقوق.
وبما أن هذه الاتفاقات في كامب ديفيد، لم تأخذ بعـين الاعتبار شمولية الحل وعدالته والوضوح فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، لذلك لم تكن هذه الاتفاقات سوى صدى للماضي ونادراً ما ينظر إليها على أنها نموذج أو خطة عمل متكاملة لحل الـصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن أن تجربة العقود الماضية أوحت بالتأكيد بعدم جدوى محاولة التنبؤ بالمستقبل في منطقة متقلبة الأحوال مثقلة بالقضايا المعقدة والصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط.
هل سلمت #مصر أوراق المنطقة لإسرائيل ومهدت الطريق أمامها لمعاهدات سلام مع باقي العرب؟ #أربعون_عاما_على_كامب_ديفيد.. … https://t.co/FhtrEo4Arl
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 17, 2018