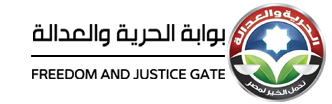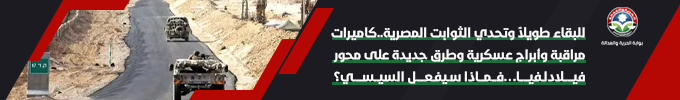فى ذكرى حدث الهجرة النبوية يسترعى الانتباه مواقفُ عددٍ من الكفار المشاركين فيها، بقصد أو بدون، وهى مواقف رائعة، تؤكد نفاسة المعدن العربى وتحضُّرَه، وإعلاءَه قيم الصدق والمروءة والعفاف والوفاء؛ ما جعلهم أوْلى باحتضان الرسالة الخاتمة من غيرهم.
نسوقُ هذه النماذج لنقارنها بالنماذج الضالة التى أفرزتها حضارة القرن الحادى والعشرين، التى تغدر وتخون حتى أبناء ملتها، وقد تجرَّدت من المشاعر والقيم الإنسانية وانتكست فى داخلها فطرة الله التى فطر الناس عليها؛ من ثم نؤكد أن الحضارة الحقيقية هى القائمة على العدل والإنصاف، والنجدة والإحسان وما عداها فهو حضارة مادة وشهوات، وهذه لا تعرف سوى الظلم والعدوان وقانون الغاب.
أول هذه المواقف هو موقف «عثمان بن طلحة» مع السيدة «أم سلمة» يوم هجرتها، وقصتها مشهورة فى كتب السيرة؛ إذ بعدما أذن لها ذووها بالانطلاق إلى زوجها فى المدينة بعد عام من الحبس، كان عليها أن ترتحل وحيدة مع ابنها «سلمة».. ونتركها لتحكى ما جرى لها؛ تقول (رضى الله عنها):
ارتحلتُ بعيرى، ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة، وما معى أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلّغ بمن لقيت، حتى أقدم على زوجى.. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت «عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» أخا بنى عبد الدار. فقال لى: إلى أين يا بنت أبى أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجى بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت لا والله إلا الله وبُنَىَّ هذا. قال: والله ما لك من مترك.
فأخذ بخطام البعير، فانطلق معى يهوى بى، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بى، ثم استأخر عنى، حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيرى فحط عنه، ثم قيده فى الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله، ثم استأخر عنى فقال: اركبى، فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه، فقاد بى حتى ينزل بى، فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك فى هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلاً، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعًا إلى مكة.
قالت: والله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة، وما رأيت صاحبًا قط أكرم من عثمان بن طلحة».
وثانى هذه المواقف هو موقف «سراقة بن مالك»؛ إذ لما خرج النبى (صلى الله عليه وسلم) من مكة مهاجرًا اغتاظت قريش، ورصدت مائة ناقة لمن يأتى به حيًّا أو ميتًا، وانتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب وضواحى مكة. وطمع «سراقة بن مالك بن جُعْشُم» فى نيل المكافأة، فأعد فرسه وخرج متعقبًا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومَنْ معه.. ولكن قدرة الله (تعالى) منعته من ذلك، لكنه فى النهاية حفظ عهده مع النبى وصاحبه فلم يش بهما، بل صار مدافعًا عنهما مضللًا قومه إزاءهما.
يقول: (بينما أنا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مُدْلِج أقبل رجلٌ منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد رأيت آنفًا أسودة (الأشخاص يُرون من بعيد) بالساحل أراها محمدًا وأصحابه، قال سراقة: فعرفتُ أنهم هم، فقلتُ له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا بأعيننا..
ثم لبثتُ فى المجلس ساعة، ثم قمتُ فدخلتُ فأمرتُ جاريتى أن تخرج بفرسى وهى من وراء أكمة (رابية) فتحبسها علىَّ، وأخذتُ رمحى فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بِزُجِّه (أسفله) الأرض وخفضتُ عاليه حتى أتيت فرسى فركبتها، فرفعتُها تقرِّب بى حتى دنوتُ منهم فعَثَرَتْ بى فرسى فخررتُ عنها..
فقمتُ فأهويتُ يدى إلى كنانتى فاستخرجتُ منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره، فركبت فرسى وعصيت الأزلام تقرِّب بى حتى إذا سمعتُ قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررتُ عنها، ثم زجرتها فنهضتْ، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثان (دخان) ساطع فى السماء مثل الدخان، فاستقسمتُ بالأزلام فخرج الذى أكره، فناديتهم بالأمان، فوقفوا فركبت فرسى حتى جئتهم..
ووقع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآنى (لم يأخذا منى شيئًا) ولم يسألانى، إلا أن قال: أخفِ عنا، فسألته أن يكتب لى كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أديم (جلد)، ثم مضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.).
أما الموقف الثالث فهو موقف «عبد الله بن أريقط»، من بنى «الديل بن بكر»، وكان مشركًا، اختاره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دليلًا فى طريق هجرته، وكان «هاديًا خريتًا»، أى دليلًا ماهرًا؛ حيث دفع إليه النبى وأبوبكر راحلتين فكانتا عنده يرعاهما لميعاد الهجرة، وقد واعداه غار ثور بعد ثلاثة أيام، فما تخلف، وما أبلغ عنهما طمعًا فى المكافأة، وما خدعهما، بل سلك طريقًا لا تهتدى إليه قريش؛ إذ أخذ طريق الساحل متجهًا إلى اليمن فى البداية؛ تضليلًا لملاحقيه، وقد نجحت خطته وأدخل النبى ومن معه المدينة سالمين، ولم تنته مهمته عند هذا الموقف، بل عاد محملًا برسائل إلى عبد الله بن أبى بكر، وبصحابة آخرين عادوا معه إلى مكة لاصطحاب أهلهم وذراريهم.