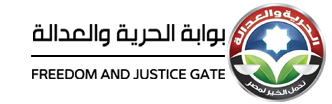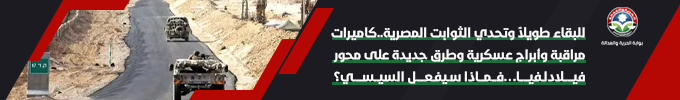يأتي العيد ليكشف في كل مرة الأعداد الحقيقية في القاهرة والمدن الجديدة لدرجة أن العيد بات موسما للسرقة في كليهما فكسر الأقفال الموضوعة على الشقق بات اسهل فلن يجد غياثا أو "صريخ ابن يومين".
وفي الأعياد تصبح شوارع القاهرة والجيزة خالية الوفاض إلى حد بعيد قد يكون جزء منه الإجازة إلا أن الجزء الأكبر هو أن أغلب سكان القاهرة والجيزة من الأقاليم التي تزدحم فيهما مواقف سيارات الأجرة والقطارات وحجوزات الباصات في اليومين الأخيرين قبل العيد بما في ذلك يوم الوقفة.
الباحث محي خطاب Mohey Khattab أشار إلى أن "السبب الرئيسي هو أن عدد الوافدين من الدلتا والصعيد إلى القاهرة الكبرى ( الهجرة الداخلية ) عدد ضخم جدا وغالبيتهم يفضلون قضاء الأعياد في مسقط رأسهم".
وعزا إليهم سبب "انتشار العشوائيات التي لم تكن موجودة قبل الخمسينيات " حيث يفضل المهاجرون الداخليون العيش بأقل توفير يتوافق مع مستوى الدخل.
والظاهرة مرتبطة بنتائج 23 يوليو حيث قلص "عبد الناصر" الرقعة الزراعية وخنق القاهرة الكبرى بالمصانع والاسمنت وأقام المساكن الشعبية لتستوعب الوافدين ومن ثم أصبحت كل محافظات مصر طاردة للسكان ".
وأضاف أن السادات حاول "إعادة توزيع السكان خارج القاهرة عبر إنشاء مدن جديدة بظهير زراعي وصناعي مثل ٦ أكتوبر والسادات و١٥ مايو والعاشر من رمضان والشروق والعبور لكنه رحل مبكرا ".
ورأى أن "..الحل ليس في إنشاء عاصمة متاخمة للقاهرة تزيد من تخمتها ولكن عبر العودة إلى اللامركزية في الخدمات وفرص العمل ".
القرية لم تعد قرية!
وعن رد الفعل العكسي من المهاجرين من الريف إلى المدن، كتب الصحفي والأكاديمي د.عمار على حسن في مايو قبل الماضي عما أسماه "غربة القرى" وأوضح كيف "تحولت القرية المصرية في العقود الأخيرة تحولًا ظاهرًا، زاد بنيانها رأسيًا بالحديد والأسمنت، وأفقيا بالاقتطاع من الرقعة الزراعية، مع النمو السكاني المتواصل، واندمجت أكثر في الزمن المعاصر، بعد أن باتت الطريق مفتوحة أمام ساكينها على العالم من خلال شبكة الإنترنت، بعد انفتاح أقل تم عبر الأقمار الصناعية ومحطات التلفزة. ".
وأضاف "أنا من جيل رأى القرية في تحولها من حال استقرت عليه آلاف السنين، إذ ظلت أدوات الزراعة وبعض أواني المنازل هي التي كان المصريون قبل الميلاد يستعملونها. ولمَّا رأيتها تنجرف مع التحديث سارعت إلى بث الحنين إليها، واصفًا إياها في كتاب قصصي حمل عنوان "عجائز البلدة" صدر عام 2020".
وتابع: "ذهب المحراث البلدي الذي كان يجره ثور، وجاء الجديد المعلق في ذيل جرار زراعي، وذهبت المذراة الخشبية البسيطة التي كانت تذور الغلة، مشتاقة إلى النسيم، لتأتي آلات تفصل الحَبَّ عن التبن، واستولت العزاقة الآلية على بعض دور الفأس، وميكنة الري على ما كان للطنبور والشادوف والساقية، وشاركت الموتورات والطائرات في رش المبيدات إلى جانب المقاومة اليدوية التي ساهمت فيها طفلًا..".
وزاد "دخلت الآلات إلى البيوت بعد اعتماد طال على الجهد العضلي للنسوة، ووسائل النقل أزاحت من طريقها الدواب، وحل البوتجاز مكان الكانون، والدفاية الكهربائية محل المنقد، وجاءت الثلاجة لتنهي عهد الحفظ بالتمليح والتجفيف والتوابل، والغسالة الأوتوماتيكية مكان الطست، والأسّرِة اللينة مكان الحُصر التي كانت تصنع من أعواد الحلفا والبوص والبلاستيك، وفُرشت السجاجيد مكان الأبسطة والأكلمة القديمة، وانتصبت الدواليب المصنوعة بعناية مكان السحارات التي تنغلق على الملابس، وأكلت المخابز الآلية في طريقها الأفران البلدي".
ورأى أنه ".. تغيرت القرية ليس بفعل شرائح المتعلمين فقط، بل أيضًا في ركاب موجات الهجرة المتوالية لأبنائها، الذين تعاقبوا بالملايين على العمل في بلاد النفط على يمين مصر وشمالها، وأولئك الذين تمكنوا من العبور إلى أوروبا. ومكث هؤلاء سنوات في أماكن كدحهم الجديدة، يجمعون المال، ويعيدونه إلى أهلهم، أو يعودون به، ليشيدوا البيوت الفاخرة، ويغيروا أنماط العيش وطرائقه، بما يضع القرى على أبواب المدن، أو يحولها إلى مدن شائهة".
المقال الذي رصد التغييرات بين القرية والمدن أشار إلى أن "بعض أبناء الأسر الريفية استقروا في البنادر، دون أن يقطعوا الصلة بأهلهم في القرى، حتى أن بعض الأسر انقسم بين المكانين، يتبادلون الزيارات والخبرات، فلم يعد لأي منهم أن يندهش كما حدث لبطل قصة يوسف إدريس "مشوار" الذي ظل طوال الوقت يصف حي الضاهر بالقاهرة الذي حل فيه خلال فترة تدريبه كمتطوع في الداخلية، أو كما حدث لبعض أبطال رواية عزت القمحاوي "بيت الديب" حين جاءوا من قرية بسيطة تمددت على نواة من أعشاش وأكواخ حين وصلوا إلى الزقازيق، واندهش بعضهم أكثر حين رأى القاهرة".
كما رصد تأثيرات "التغير في أحوال المعيشة" وما أدى "إلى اشتعال روح المنافسة، بل الصراع، بين ساكني الريف، ومعه قلت الأعذار التي كان يبديها البعض حيال الذين يتوعكون في سباق الحياة الطويل، أو النظر بعين العطف إلي من لا يملكون سبل التمكن المادي بمرور الوقت. صار الجار ينظر إلى ما في يد جاره، والفتاة رقيقة الحال تنظر متحسرة إلى حال نظيرتها الموسر أهلها. وتسابق الشباب في البحث عن مال بأي شكل، سفر إلى الخارج أو سمسرة وأحيانًا التعليم أو شراء أرض الغير بأي ثمن".
وخلص إلى أن الريف المصري "لبس قشرة حداثة، هي أشبه بطلاء فاقع لونه، بينما بقيت الجدران على حالها تئن تحت وطأة هلاك ينخر الأرواح، ويعبث بالقيم. صرنا أمام قرى أشبه بمدن مشوهة، تنافس ظاهرة "تريف المدن" في الحال والمآل، وأصبحنا أمام تحولات فقدت قانون التطور الطبيعي، وجلبت الاغتراب الذي غاب عن أهل الريف قرونًا طويلة.".
وانتهى إلى أن "آخر مكان كان المرء يعتقد أن بعض أهله سيعانون من الغربة هو القرية. ففي السابق كان يمكن لمن يعيش في الريف أن يشكو من ضيق ذات اليد، أو من الملل والرتابة، لكن أن يضج من الغربة فهذا ما لم يكن في الحسبان.
https://www.facebook.com/marlyhsn.148844/posts/pfbid02rE7DVTf7NJY6zFxsQqVR26TL6ZY4rLiB9nZ3mxXP4BTcVF42N1GLKdhaWQkXh5KXl